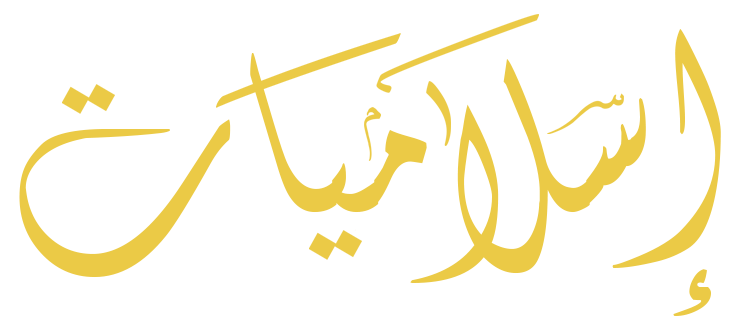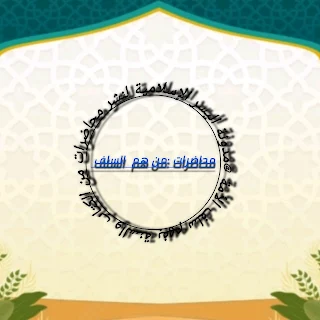*اعتقادهم في الله*
قال المؤلف رحمه الله:
وقوله: (فرد، صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد).
الشرح:
الفرد ليس من أسماء الله، فيما يظهر، فلا يسمّى الله به ولا يُدعى به، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، لكن يجوز الإخبار به عن الله عز وجل، لأنه بمعنى الأحد، كما سبق في تفسير “الأحد”، وفسره بعضهم بأن “الفرد” هو الواحد الأحد، أو أن الواحد والأحد هما الفرد. وقيل: هو بمعنى الوتر، كما ذكر الخطابي في شأن الدعاء: “الوتر الفرد”. وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: “الوتر الفرد الذي لا شريك له ولا نظير”، وهذه صفة يستحقها الله بذاته.
وقال ابن الأثير في جامع الأصول: “الوتر الفرد”. وقد ذكر هذه اللفظة جمع من أهل العلم، من أهل السنة، في كتبهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذكرها أيضًا الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، رحمهم الله جميعًا، ومعناها صحيح، أي أنها بمعنى الأحد، كما سبق، وكون أهل العلم قد ذكروا أو وصفوا الله عز وجل بها أو أخبروا بها عنه، فإنهم يقصدون بذلك الإخبار، لا أنها اسم يُطلق من باب التسمية. والله أعلم.
وأما *(الصمد)*.. فمعناه: الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، بل كل من في السماوات ومن في الأرض مفتقرون إلى الله عز وجل غاية الافتقار، لأنه عز وجل هو الكامل في أوصافه.
وأما قوله: *(لم يلد ولم يولد)*
فقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، وذلك لكمال غناه عز وجل.
وأما قوله: *(ولم يكن له كفوا أحد)*،
أو كفوا أحد، فمعناه: لا مثيل له في أسمائه، ولا في أوصافه، ولا في أفعاله تبارك وتعالى. وقد نقل ابن كثير عن مجاهد في تفسير الآية: “يعني لا صاحبة له”، وهذا كما قال الله تعالى: {بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء}،
فُسّر “كفوا أحد” بأنه ليس له مثيل أو نظير في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، وفسر أيضًا بأن المراد أنه لا صاحبة له، والله أعلم.
*اعتقادهم في الله*
قال المؤلف رحمه الله: قوله:
*(وأنه الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء)*
الشرح:
هذا دليله قول الله تعالى: {هو الأول والآخر والظاهر والباطن}، وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأسماء والصفات، بقوله في الحديث الصحيح: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء). حديث أخرجه الإمام مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقوله *(خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)*
يعني لقوله تعالى: {هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش}، والآيات الدالة على استوائه على العرش ذكر أهل العلم أنها ست آيات أو سبع، دالة على استوائه عز وجل استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو بمعنى (علا وارتفع)
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية السابقة: "يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم، سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن، والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، يعني في يوم الجمعة، وفيه خلق آدم عليه السلام." انتهى.
ثم استدل بما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد… الحديث.
والله عز وجل خلقها على هذه الصفة لحكمة، مع أنه جل وعلا قادر على خلقها في لحظة واحدة، كما قال تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون}. لكنه عز وجل خلقها على هذه الصفة لحكمة، بل لحكمة بالغة.
من المسائل المهمة التي كَثُر فيها الخلاف، واختلطت فيها العقائد عند كثير من الناس، فوجب توضيحه وبيان الحق فيه.*
*اعتقادهم في الله..*
قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله: (ثم استوى على العرش)
شرح الشيخ أحمد عبدالله الحكمي حفظه الله (احد طلاب الشيخ احمد النجمي):
في هذا أو دليل هذا سبع آيات في كتاب الله تعالى، وأن الله تعالى فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، لا يخفى عليه شيء من خلقه، مستوٍ على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، وهو هنا بمعنى العلو والارتفاع، أو علا وارتفع، كما سبق. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الجهمية، أخزاهم الله، ومن وافقهم من المعتزلة والخوارج والأشعرية، لأن معنى “استوى” (عندهم) "استولى”، وهذا قول باطل من عدة وجوه.
أولاً: أن هذا التفسير معتمد على أصول فاسدة، لأنهم لم يتصوروا إثبات صفات الله تعالى إلا مع التشبيه والتمثيل، يعني بصفات المخلوقين أو بصفات خلقه، وعموا عن قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، فهم عملوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه، كما فعلت اليهود، أخزاهم الله.
ثانياً: أن هذا الكلام لا تعرفه العرب، فإن علماء اللغة، بل وحتى التفسير وغيرهم، لما بلغهم قول الجعد بن درهم –وهو مؤسس عقيدة الجهمية– ردوا عليه وأنكروا ذلك، وقالوا إن هذا لا يوجد في لغة العرب، لأنه استدل بقول الأخطل –وأظنه يهوديًا أو رجلًا لا يعرف الإسلام– فاستدل بقوله على أن “استوى” (يعني) “استولى”، فرد عليه أهل السنة والجماعة، وأنكروا عليه ذلك، وقالوا إن هذا لا يوجد في لغة العرب، ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، ولا في كلام التابعين رحمهم الله.
ثالثاً: أن في تفسير الاستواء بالاستيلاء تنقصٌ لله عز وجل، لأنه يدل على أن لله تعالى مغالبٌ –تعالى الله عن ذلك–، والله تعالى هو القاهر فوق عباده، كما قال تعالى: {وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير}
أنتم بزعمكم هذا –أن الاستواء بمعنى الاستيلاء– بزعمكم هذا— تتنقصون الله عز وجل!، لأن هناك من هو مغالب له، وهذا التفسير يعارض هذه الآية، أي قوله تعالى: {وهو القاهر فوق عباده}، بل ويعارض مئات الأدلة، الدالة على فوقيته، وعلوّه على جميع خلقه: علو ذات وصفة وقدر وقهر.
رابعاً: هذا القول الذي اعتمدوه أخذوه –كما سمعتم– من بيت شعر نسب إلى نصراني يُقال له الأخطل، وهو قوله: "قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق"، ونقول لهم: يا للعجب! تعارضون كلام الله عز وجل ببيت نصراني ضال! لكن… لكن هو الضلال، أي أنكم لضلالكم ذهبتم إلى هذا وتركتم نصوص الكتاب.
خامساً: استواء الله على عرشه يدل على علوّه تعالى على جميع خلقه، والعلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، بل ذكر بعضهم أن أدلة علوّه تبارك وتعالى على خلقه تبلغ إلى ألف دليل، والاستواء على العرش أخص من العلو، فالعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة ذاتية فعلية.
*اعتقادهم في الله*
قال الشيخ العلامة احمد النجمي رحمه الله: (ثم استوى على العرش)
شرح الشيخ احمد بن عبدالله الحكمي حفظه الله:
وأما ما جاء من تفسير أرُويَ عن ابن عباس ذلك، لكنه لا يصح عنه فيما يُعلم، ولأن فيه تأويلٌ لهذه الصفة، تنزه عنها هذا الصحابي الجليل.. في هذا القول تأويل لهذه الصفة يتضمن نفيها، ولا يمكن أن يقوله ابن عباس رضي الله عنهما.
ومنهم من فسّر العرش بالكرسي، وهذا مروي عن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله، لكن هذا أيضًا غير صحيح؛ فإن العرش غير الكرسي. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
«الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره»،
وهذا أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على المريسي، وأبو جعفر يعني ابن أبي شيبة أخرجه في كتابه العرش، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأبو الشيخ في العظمة - أي في كتابه العظمة - وأخرجه الدارقطني في كتاب الصفات.
قال الشيخ الألباني في مختصر العلو: «إسناده صحيح كلهم ثقات».
والعرش أعظم من الكرسي، بل هو أعظم المخلوقات كلها، وهو سقفها. وقد روي في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«السماوات السبع في الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة».
أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش، وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وابن جرير الطبري في تفسيره، وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وأورد له عدة طرق، ثم قال: «وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح، وخيرها الطريق الأخير والله أعلم» يريد طريق ابن جرير الطبري رحمه الله.
ثم قال: «والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى {وسع كرسيه السماوات والأرض} وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش»، انتهى.
وفي صحيح البخاري: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن». وهذا الأخير هو الشاهد: «وسقفها عرش الرحمن».
والله تعالى أعلم
*اعتقادهم في علم الله*
يقول شيخنا العلامة احمد النجمي رحمه الله: (يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم)
الشرح للشيخ احمد الحكمي:
ثم استدل بقوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد}.
أقول: من الأدلة أيضًا قوله تعالى: {والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليمًا حليمًا}، وقوله تعالى: {يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور}، وقوله تعالى: {واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه}. والآيات في هذا المعنى كثيرة. في هذه الآيات وغيرها إثبات علم الله تعالى المحيط بكل شيء.
يقول ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب الجهمية والمعطلة: “وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، وأن الله يعلم ما كان وما يكون”.
قال رحمه الله: “وأن الله يعلم ما كان وما يكون”.
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في قوله تعالى: {قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورًا رحيمًا}، قال: أي أنزله عالم الخفيات، ورب الأرض والسماوات، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.
قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير في قوله تعالى: {ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير}، قال: إن ذلك يعني ما يجري في السماوات والأرض في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ.
وقال البغوي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: {في كتاب}, قال: يعني اللوح المحفوظ.
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه، وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ.
كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء”.
وقال أيضًا: وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى (القلم) بما هو كائن إلى يوم القيامة."
ثم قال: وهذا من تمام علمه تعالى، أنه علم الأشياء قبل كونها، وقدرها وكتبها أيضًا، فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك، على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده، وأحاط بكل شيء علمًا، وهو سهل عليه يسير لديه، إلى آخر ما ذكر.
اعتقادهم في علم الله
قال المؤلف رحمه الله: (يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم—)
شرح الشيخ احمد الحكمي:
يقول شيخنا احمد النجمي رحمه الله: (يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم—) إلى آخر كلامه.
ثم استدل بقوله تعالى:
{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}.
أقول: من الأدلة أيضًا قوله تعالى:
{وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا}،
وقوله تعالى:
{يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}،
وقوله تعالى:
{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ}.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
في هذه الآيات وغيرها إثبات علم الله تعالى المحيطِ بكل شيء.
يقول ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب الجهمية والمعطلة:
“وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، وأن الله يعلم ما كان وما يكون”.
قال رحمه الله: “وأن الله يعلم ما كان وما يكون”.
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في قوله تعالى: {قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}،
قال: أي أنزله عالم الخفيات، ورب الأرض والسماوات، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.
قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير في قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}—قال: إن ذلك يعني ما يجري في السماوات والأرض {في كتاب}—يعني في اللوح المحفوظ.
وقال البغوي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: {في كتاب} قال: يعني اللوح المحفوظ.
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه، وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ.
كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء)
وقال أيضا: وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.)
ثم قال:
وهذا من تمام علمه تعالى، أنه علم الأشياء قبل كونها، وقدرها وكتبها أيضًا، فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك، على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره، وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده، وأحاط بكل شيء علمًا، وهو سهل عليه، يسير لديه، إلى آخر ما ذكر.
اعتقادهم في علم الله
قال المؤلف رحمه الله: (يعلم ما كان وما يكون…)
قال الشارح الشيخ احمد الحكمي:
وقال السعدي رحمه الله: فهو يعلم ما كان، وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أحوال المكلّفين منذ أنشأهم، وبعد ما يميتهم، وبعد ما يحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها، خيرها وشرها، وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. انتهى.
يعني: أنه يعلم ذلك كله. وقوله في الآية السابقة: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه} — تفسير هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله: يقول يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان، بأنه خالقه، وعلمه محيط بجميع أموره، أي أن الله خلق الإنسان، وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيحين، أو قال: ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل”. الحديث.
اعتقادهم في علم الله
قال المؤلف رحمه الله: (قال تعالى {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد}
الشارح الشيخ احمد الحكمي:
يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، والله أعلم.
وهنا مسألة، وهي أن غلاة القدرية ومن وافقهم ينكرون علمه تعالى المتقدم، وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف، يعني مستأنف. هذا قاله غلاة القدرية، ووافقهم في ذلك الرافضة. وكان أول من أظهر ذلك هو معبد الجهني بالبصرة، ولما بلغ الصحابة رضي الله عنهم قوله هذا وقول من وافقه، تبرؤوا منهم، وأنكروا عليهم هذه المقالة، كما في صحيح مسلم بسنده عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلاً المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، هذا من يقوله؟ يقوله يحيى بن يعمر. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أنا: فقلت: أبا عبد الرحمن (وهذه كنية ابن عمر رضي الله عنهما). قال: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقثرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أُحد ذهبًا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الطويل، في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان.
قال ابن أبي العز (يعني شارح الطحاوية): فإنه سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن، أن لو كان، كيف يكون، كما قال تعالى: {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه}، وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: {ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون}.
وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، هذا الشاهد هنا. قال: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. انتهى.
أقول: من الأدلة على ذلك أيضًا، قوله تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير}.
قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره “زاد المسير”: قوله تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض} يعني قحط المطر، وقلة النبات، ونقص الثمار، {ولا في أنفسكم} يعني من الأمراض وفقد الأولاد، {إلا في كتاب} وهو اللوح المحفوظ، {من قبل أن نبرأها} أي نخلقها، يعني الأنفس، {إن ذلك على الله يسير}، أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل. انتهى.
وفي تفسير البغوي رحمه الله، وابن كثير رحمه الله أيضًا، نُقل ذلك.
وروى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بسنده عن منصور بن عبد الرحمن، قال: كنت جالسًا مع الحسن، فقال رجل: سله عن قوله: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها}، قال: فسألته عنها، فقال: سبحان الله! ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يُبرأ النسمة، أي من قبل أن يُخلق الإنسان نفسه، أو يُخلق الخلق.
قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية، من أدل دليل، يعني في الرد على القدرية نفاة العلم السابق، قبحهم الله.