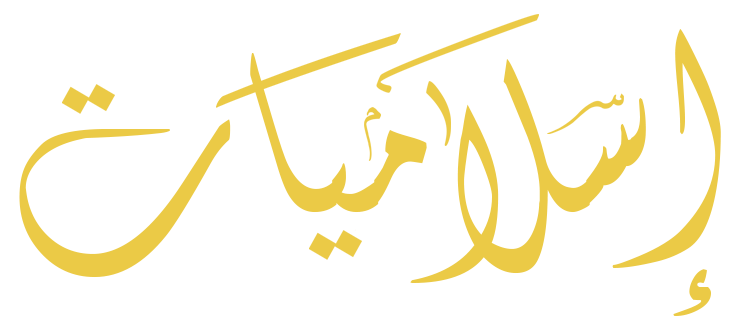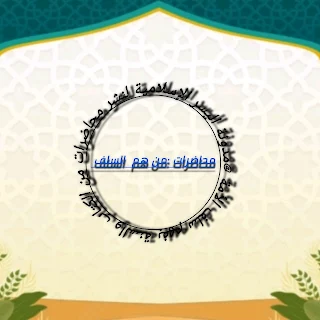اعتقادهم في الإيمان:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله: (تعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)
قال الشارح الشيخ احمد الحكمي حفظه الله:
هذا الذي ذكره شيخنا هنا رحمه الله هو معتقد أهل السنة والجماعة، والإيمان قول وعمل، كما قال بعض أهل العلم أو بعض أهل السنة، وقال بعضهم: قول وعمل ونية، وقال بعضهم: قول وعمل ونية يعني واعتقاد.
والمراد بقولهم “قول”: أي قول القلب، وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان، وهو النطق.
والعمل: أي عمل القلب كالإخلاص والمحبة ونحوهما، وعمل الجوارح، وكذلك عمل اللسان. أما عمل اللسان فقط كقراءة القرآن وذكر الله والنطق بالشهادتين، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك.
والدليل على هذه الأركان الثلاثة: فإن الإيمان لا بد فيه من هذه الأركان: القول والاعتقاد، أو قول وعمل واعتقاد.
الدليل على هذا قول الله تعالى:
{ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم}
فهذه الآية تشتمل على قول القلب وعمله. فقوله: أي قول القلب، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعمله: إرادته وحركاته وتوجهاته كالمحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك.
ومن الأدلة قوله تعالى:
{فآمنوا بالله ورسوله}
وهذه الآية تشتمل على عمل القلب واللسان؛ إذ واجب الإيمان بالله الشهادة له بالتوحيد، وواجب الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن نشهد له بالرسالة، ولا بد من اعتقاد لهما، وكذلك لا بد من نطق بهما.
ومن الأدلة قوله تعالى:
{وما كان الله ليضيع إيمانكم}
وهذه الآية المقصود بها: صلاتكم إلى بيت المقدس.
وهذه الآية متضمنة لعمل القلب واللسان والجوارح؛ فالصلاة تتضمن:
• عمل القلب: بصدق النية والإخلاص وأدائها خوفًا ورجاءً ومحبة.
• وتتضمن النطق باللسان: من القراءة والذكر والتسبيح والدعاء ونحو ذلك.
• وتتضمن العمل بالجوارح: من قيام وركوع وسجود وجلوس ونحو ذلك.
فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قولًا وعملًا واعتقادًا، كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى هنا.
وقد اختلفت عبارات السلف في الإيمان، إلا أنها بمعنى واحد، كما سبق؛ منهم من قال: قول وعمل واعتقاد، ومنهم من قال: قول وعمل، كلها بمعنى واحد.
يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة:
باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنًا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث.
يعني لا يكون الإنسان مؤمنًا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. ثم ذكرها وذكر الأدلة على ذلك.
قال رحمه الله:
“اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب، فالتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقًا، ولا تجزئ المعرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنًا.”
ثم قال:
“دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين.”
ثم ذكر الأدلة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان:
“إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة.”
قال: “من شعائر السنة.”
ثم قال: “وحكى غير واحد الإجماع على ذلك.”
وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك في الأم، يعني في كتابه الأم.
قوله: “وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم، يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يُجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.”
وهذا واضحٌ بيّن.
ولهذا: من أخرج العمل من مسمى الإيمان، فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، وخرج عن طريقتهم، كما فعلت المرجئة. وهم أقسام، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان.
ولما قال جماعة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، رد عليهم أهل السنة والجماعة، وأضافوا في اعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص، أو يتفاضل.
ومن الأدلة على اجتماع هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا بد منها:
• قول الله تعالى:
{من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان}
• وقوله تعالى:
{قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط…}
• وقوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم…}
فهذه الآيات فيها أن الإيمان لا بد أن يكون:
• في القلب: في الإقرار والاعتقاد.
• وفي اللسان: النطق بالشهادتين ونحوهما.
• وعمل بالجوارح.
وعمل الجوارح دليل يصدق ما في القلب وما يجري به اللسان.
قال الإمام الآجري رحمه الله:
“فالأعمال رحمكم الله بالجوارح، تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنًا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه.” انتهى
اعتقادهم في الإيمان
قال المؤلف رحمه الله: (تعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)
قال الشارح الشيخ أحمد عيد الله الحكمي حفظه الله:
والإيمان كما قال شيخنا هنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول علماء السلف رحمهم الله.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: "الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص
البر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان أو تنقص من الإيمان"
ومن الأدلة على زيادة الإيمان:
قول الله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًۭا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ}
وقول الله تعالى: {وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَـٰنًۭا}
ومن الأدلة على نقصانه:
حديث (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداهن)
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن يُقال إن كان الإيمان ينقص اضطرارًا، فمن باب أولى أن ينقص اختيارًا، لأن يترك العبد الطاعة ويفعل المعصية، فينقص بذلك إيمانه.
وقد روى الآجري رحمه الله في الشريعة بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهما قالا: "الإيمان يزداد وينقص"
وبوّب الإمام البخاري والإمام الترمذي رحمهما الله تعالى بما يدل على ذلك
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب زيادة الإيمان ونقصانه)
وقال الترمذي: (باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه)
وقد نقل حرب الكرماني رحمه الله في مسائله للإمام أحمد عن أهل العلم وأصحاب الأثر أنهم يقولون ذلك. أن “الإيمان قول وعمل ونية، وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص”
وذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد إجماع أهل الحديث وأهل الفقه على ذلك، قال: “الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان”
وكذلك ذكر الإمام البغوي في شرح السنة، قال “اتفقت الصحابة والتابعون، فمن بعدهم من علماء السنة، على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء”
ومن الأدلة أيضًا على نقصانه:
حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه (والذي نفسي بيده، إن لو تدوموا على ما تكونون عندي في الذكر، لصافحتكم الملائكة)
وجه الدلالة: أنه دال على تغيّر الإيمان وتغيّر الحال—قال بعض أهل العلم: “إنما يتغير بالنقصان” أو “التغير إنما يكون بالنقصان”
ومن الأدلة كذلك على أن الإيمان ينقص بالمعاصي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم—(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
فهذا الحديث فيه أن الإيمان يضعف
قالوا: "وسبب ضعفه، وسبب ذلك هو نقصانه"
دل هذا الحديث على أن الإيمان يضعف، أي ينقص
وقال الإمام أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد، وذكر ابن عيينة – أي سفيان بن عيينة – فقال “يقول الإيمان يزيد، ولا يُعَيَّب من قال ينقص”
أي لا يُعاب على من قال: ينقص، لأن بعض السلف توقفوا في مسألة القول بالنقصان، وقالوا: لا دليل على ذلك، فسمعت بعض الأدلة الدالة على ذلك
وقال أيضًا: سمعت أحمد – أي الإمام أحمد – يقول “سمعت سفيان يقول: لا يُعنّف من قال: الإيمان ينقص”
وأخرج ابن أبي عمر في كتابه الإيمان أن سفيان بن عيينة رحمه الله قال “الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص” فقال له أخوه إبراهيم: يا أبا محمد، لا تقل ينقص فغضب وقال: “اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
قال المؤلف رحمه الله: ..
قال الشارح الشيخ احمد الحكمي:
وقد ضل في هذا الباب طائفتان، سبقت معنا أو سبق ذكرها أظنه في شرح أصول السنة، الطائفة الأولى هم الوعيدية—وهم الخوارج والمعتزلة، الذين حكموا بأن مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين حكموا عليه بالخلود في النار، واختلفوا فيه في الدنيا، وقالوا - أي قال الخوارج - إنه في الدنيا كافر.
ولهذا استحل الخوارج قتال المسلمين، استحلوا دماءهم وأموالهم، وعاثوا في بلادهم فسادًا في بلاد المسلمين. وأما المعتزلة فقالوا هو في منزلة يعني في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر.
والطائفة الثانية: هم المرجئة، الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أو أخرجوه من حد الإيمان وتعريف الإيمان، وهؤلاء أصناف:
من يقول إن الإيمان هو مجرد ما في القلب أو هو معرفة الرب بالقلب، كما قالت الجهمية.
ومنهم من قال التصديق بالقلب كالأشاعرة ومن وافقهم.
ومنهم من قال مجرد قول اللسان أو مجرد أن تنطق بلسانك، يكفي ذلك كما فعلت الكرامية.
ومنهم من قال هو تصديق القلب وقول اللسان وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء.
وكل هؤلاء مخطئون، مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة، وأقوالهم يترتب عليها مفاسد، بل مفاسد عظيمة، يأتي إن شاء الله بيان شيء منها في بعض الدروس.
ثم قال شيخنا رحمه الله: (إن تارك العمل زنديق غير صادق في ادعائه الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح. )
لا شك أن العمل عند أهل السنة والجماعة كما سمعتم داخل في حد الإيمان، وأن الإيمان مؤلف من ثلاثة أشياء لا بد منها:
الاعتقاد
والقول
والعمل
وهي أركان، ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر، لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل، والسلف الصالح رحمهم الله يكفرون تارك العمل بالكلية. وهذه المسألة كما قد ذكرت لكم في شرح مضى يطول بحثها.
اعتقادهم في الإيمان
قال المؤلف رحمه الله: (وأن تارك العمل زنديق، غير صادق في ادعائه للإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان في كتابه إلا وذكر معه العمل الصالح)
قال الشارح الشيخ احمد الحكمي حفظه الله:
أقول: العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان، وأنه لا بد منه، وأن الإيمان لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء، وهي: الاعتقاد، والقول، والعمل. وهذه هي أركان الإيمان، ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر، لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل.
والسلف الصالح رحمهم الله، كما سيذكر شيخنا، يكفرون تارك العمل، أي: تاركه بالكلية، وقد نُقل الإجماع على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به، عن غير واحد من أهل العلم من علماء أهل السنة.
فقد نقل اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة عن الإمام الشافعي أنه ذكر الإجماع على ذلك، حيث قال:
“كان الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.”
وكذلك نقل الحميدي رحمه الله الإجماع على ذلك، وقال:
“أخبرته أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، أو صلى مستدبر القبلة حتى مات، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة.”
فقال رحمه الله: “قلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين.”
ثم قال الله عز وجل: {حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.
وقال حنبل: قال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، أو سمعته يقول:
“من قال هذا فقد كفر بالله، وردّ على الله أمره، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به.”
أخرجه الخلال في السنة.
وقال الآجري رحمه الله في الشريعة:
“الإيمان: معرفة بالقلب تصديقًا ويقينًا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنًا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض.”
وقال أيضًا: “اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.”
ثم قال: “اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نُطقًا، ولا يجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان، حتى يكون عمل الجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث، كان مؤمنًا، دل على ذلك: القرآن، والسنة، وقول علماء المسلمين.”
ثم قال: “ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقًا بما ينطق به اللسان، مع العمل"
وقال: “وأما الإيمان بما فرض على الجوارح، تصديقًا بما آمن به القلب، ونطق به اللسان، وذلك في كتاب الله تعالى كثير جداً، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.”
وقال تعالى أيضًا في غير موضع من القرآن: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح.
قال: “فالأعمال – رحمكم الله – بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنًا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه.
ونقل أيضًا الآجري في الشريعة عن بعضهم أنه قال:
“الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح، لا يسمى مؤمنًا.
وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصف من الإيمان، فإنه لا يكون مسلمًا.”
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة:
“الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه السلف. وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول: تصديق الرسول، والعمل: تصديق القول، فإذا خَلَا العبد من العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا.” انتهى
وهذا هو الشاهد، فإن خلا العبد من العمل بالكلية، لم يكن مؤمنًا. انتهى
اعتقادهم في الإيمان، ومجمل خلاف العلماء في حكم تارك الصلاة
قال المؤلف رحمه الله: (وأن تارك الصلاة كافر كفرًا يخرج من الملة، للأدلة الدالة على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}.—وقد اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، أن تارك الصلاة يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل حدًّا، على رأي الإمامين مالك والشافعي، وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما كقول مالك والشافعي، والثانية: أنه يكفر بالترك، فلذلك يُقال بأنه يُقتل كفرًا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى قتله، وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي، أي إرجاء الفقهاء. ومن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين وترك العمل، لم يكن صادقًا فيما ادعاه حتى يعمل، فإن لم يعمل استُتيب، فإن تاب وإلا قُتل كما سبق بيانه)
قال الشارح الشيخ احمد عبد الله الحكمي:
وأقول: شيخنا رحمه الله يرى أن تارك الصلاة ولو تهاونًا أو كسلًا كافر كفرًا مخرجًا من الملة، للأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، وقد ذكر هنا آية تدل على ذلك، وذكر في مواضع أخرى أدلة أخرى. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وقول عند المالكية، أن تارك الصلاة يكفر، وبه قالت طائفة من السلف، وهو أيضًا مذهب جمهور أصحاب الحديث، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولابن القيم رحمه الله رسالة بعنوان “الصلاة”، ذكر فيها أقوال العلماء، ثم رجّح القول بكفره، وكذلك اختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورحم الله الجميع، وبه أيضًا تُفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية.
لكنهم يختلفون: هل يكفر بالترك بالكلية، أو بترك فريضة أو فريضتين مشتركتين في الوقت؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، وذهب آخرون إلى أنه لو ترك فريضة أو فريضتين حتى خرج وقتها أو وقتهما عامدًا، فإنه يكفر، وإلى هذا ذهب الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وكذلك قال به بعض الحنابلة، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله، ويميل إليه شيخنا النجمي فيما أعلمه وأظنه. وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، كما مر، واختيار شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، إلى أنه لا يكفر الكفر الأكبر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية.
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في أصول السنة: “ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وقد أحل الله قتله”. والمسألة كما سمعتم أيها الإخوة مسألة خلافية، بل الخلاف فيها طويل، وقد ذكرتُ الخلاف في هذه المسألة، أظنه في شرح أصول السنة. ومجمل ذلك أن من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، فهذا لا خلاف في كفره، هو كافر بالإجماع، أي الكفر الأكبر، ولو صلى، وقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى في “الاستذكار”، قال: “وأجمع المسلمون أن جاحد الصلاة كافر، حلال دَمْهُ كسائر الكفار، كسائر الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله”. وقال: “واختلف في تارك الصلاة وهو قادر عليها غير جاحد بفرضها”، انتهى.
وقال الشوكاني رحمه الله في “نيل الأوطار”: “ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة”، ثم قال: “وإن كان تركه لها تكاسلًا مع اعتقاده لوجوبها، كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء في حكمه”، انتهى.
اعتقادهم في الإيمان، وأدلة القائلين بكفر تارك الصلاة كفرًا أكبر مخرجًا من الملة.
قال المؤلف رحمه الله: (وأن تارك الصلاة كافر كفرًا يخرج من الملة، للأدلة الدالة على ذلك، منها…إلخ)
قال الشارح الشيخ احمد عبد الله الحكمي:
أقول: من ترك الصلاة تهاونًا أو كسلًا اختلف العلماء في حكمه، هل يكفر أو لا؟ ولا شك أن هذا الأمر أمر خطير، إذا كان العلماء يختلفون في حكمه هل يكفر أو لا يكفر، دلّ هذا على شدة هذا الأمر وخطورته.
والمهم أنهم مجمعون أو قول الجمهور على أن تارك الصلاة كافر، لكن اختلفوا في نوع هذا الكفر، هل هو كفر مخرج من الملة أم لا؟ ذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن كفره لا يخرج من الملة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كفره كفر مخرج من الملة، كما مر معنا.
والذي يترجح والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن تاركها بالكلية كافر كفرًا أكبر. دليل ذلك قول الله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين}، فالله تعالى علّق هنا أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فدلّ على أن من لم يُقِم الصلاة ليس أخًا للمؤمنين. ونفي الأخوّة المطلقة دليل على كفر صاحبها.
ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”، وحديث جابر رضي الله عنه: “إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة”، وهذان الحديثان يدلان بظاهرهما على كفر تارك الصلاة. ومن الأدلة أيضًا حديث معاذ رضي الله عنه: “رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة”، قال شيخ الإسلام رحمه الله: “ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه ولم يُنتفع به” انتهى. يعني: وكذلك الصلاة، إذا ذهبت ذهب الإسلام. واستُدل أيضًا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة”.
قال شيخ الإسلام: هذا قاله بمحضر من الصحابة. وكذلك ذكر أيضًا تلميذه ابن القيم رحمه الله. وقال علي رضي الله عنه: “من لم يصلِّ فهو كافر” أخرجه البخاري في تاريخه الكبير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: “من ترك الصلاة فهو كافر”. في رواية عنه في إضاعة الصلاة، قال: هو إضاعة مواقيتها، ولو تركوها لكانوا كفارًا.
وكذلك رُوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: “من ترك الصلاة كفر”. ومن أدلتهم أيضًا ما نقله عبد الله بن شقيق من إجماع الصحابة، وما نُقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: “بلغني أن أصحاب محمد ﷺ كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يُشرك فيكفر، أن يترك الصلاة من غير عذر”.
وأثر وائل بن شقيق، أو أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، ذكره الترمذي في سننه، وصححه الشيخ الألباني، قال: “كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة”.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: “هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم”.
أقول: هذا أيضًا هو قول بعض السلف رحمهم الله، كما نقل ذلك الشوكاني في “نيل الأوطار”، قال: وذهبت جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعية، انتهى.
وكذلك ابن رجب رحمه الله قال في “جامع العلوم والحكم”: ذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، ثم قال: وقال محمد بن نصر، أظنه في “تعظيم قدر الصلاة”: هو قول جمهور أهل الحديث، انتهى—بتصرف.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه “شرح العمدة” أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه، ثم ذكرها. وكذلك أورد ابن القيم رحمه الله أكثر من 22 دليلًا على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر، كما في كتابه “الصلاة”. وقد قال رحمه الله في كتابه “تارك الصلاة”: “وقد دلّ على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم”، انتهى.
اعتقادهم في الإيمان، وأدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر مخرجًا من الملة.
قال الشارح الشيخ احمد الحكمي:
أما الجمهور رحمهم الله فإنهم يقولون إنه لا يكفر الكفر الأكبر، واستدلوا بأدلة، من أظهر هذه الأدلة حديث الشفاعة الطويل، وكذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “بدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها”. قال صِلَة: ما تُغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردّها عليه ثلاثًا، كل ذلك يُعرض عنه حذيفة رضي الله عنه، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: “يا صلة، تُنجيهم، أي: لا إله إلا الله، تُنجيهم من النار”، قالها ثلاثًا. أخرجه ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني.
واستدلوا أيضًا أو من أدلتهم حديث: “خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يُضيّع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة”. أخرجه أبو داود والنسائي. فهنا علق الأمر على المشيئة، فدلّ على أنه لا يكفر، هكذا ذكروا.
ومن الأدلة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل”، وهو في الصحيحين.
واستدلوا أيضًا بحديث صاحب البطاقة، وأنه يأتي بكلمة: “لا إله إلا الله” أو “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وترجح بجميع السيئات، ويدخل الجنة.
وكذلك حديث الشفاعة كما سبق، وفيه أن المؤمنين يقولون لربهم عز وجل: “ربنا، إخواننا، كانوا يُصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا”، فيقول الله تعالى: “اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه”، ويحرِّم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فيُخرجون من عرفوه، ثم يعودون، أي: يقولون: يا رب، يقولون: ربنا، إخواننا. فيقول الله تعالى لهم: “اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه”. الحديث.
دليل ووجه الدلالة من هذا الحديث كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه “حكم تارك الصلاة”: قال: يدل ـ أي حديث الشفاعة ـ على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في المرة الثانية، أي: المرة الأولى كانت لحق المصلين، ثم في المرة الثانية كانت لغير المصلين، قال: وما بعدها، أي: في المرة الثالثة أيضًا كانت لغير المصلين، وأنهم أخرجوهم من النار. ثم قال: فهذا نص قاطع في المسألة، ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم، انتهى
حكم تارك الصلاة وبيان متى يُستتاب وكيف يُقتل؟
قال الشارح الشيخ احمد بن عبدالله الحكمي:
والمسألة كما سمعتم: الجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر، ومذهب الحنابلة، وقول للإمام أحمد ومن وافقه، أنه يكفر الكفر الأكبر إذا ترك الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أنه إن تركها بالكلية فإنه يكون كافرًا كفرًا أكبر مخرجًا من الملة. ثم هنا مسألة: إذا دعي تارك الصلاة إلى الصلاة واستتيب وأبى أن يصلي، وعُرض عليه السيف، وقيل له صلِّ، فأبى أن يصلي، فهذا فيه دلالة على أنه جاحد للصلاة، وعلى هذا إذا مات فإنه يموت كافرًا كفرًا أكبر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأقره على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. والمسألة كما قدمت لكم مسألة خطيرة، يكفي فيها أن العلماء قد اختلفوا في حكم تاركها: هل هو مسلم أو كافر؟ كيف يطيب لعبد يقول إنه مسلم ويترك الصلاة؟ كيف يطيب لعبد يقول إنه مسلم ويتساهل بالصلاة، يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا؟ لهذا قال ابن القيم رحمه الله: “لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه (اي تارك الصلاة) عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه معرض أو متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة”. انتهى. نعوذ بالله. كيف تطيب نفس مؤمن أن يكون هذا حاله؟
بقي هنا مسألة: هل يُقتل؟ وهل يُقتل حدًّا أو كفرًا؟ خلاف أيضًا بين العلماء رحمهم الله، وقد مر معنا أن الجمهور يرون أنه يُقتل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يُقتل لكن يُحبس حتى يصلي أو يموت في الحبس. ومر معنا أيضًا أن الجاحد لوجوبها يكون كافرًا كفرًا أكبر، فيكون بذلك حلال الدم، يكون مرتدًا، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قُتل. لا شك أن الجاحد لوجوبها كافر بالإجماع كما سبق.
أما من تركها تهاونًا وكسلًا، فقد اختلف العلماء في قتله، والجمهور على أنه يُقتل كما سبق. قال ابن القيم رحمه الله: “اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. فأفتى سفيان الثوري، وأبو عمر الأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأصحابهم بأنه يُقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال الجمهور: يُقتل بالسيف ضربًا في عنقه. وقال بعض الشافعية: يُضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت. وقال ابن سريج: يُنخس بالسيف حتى يموت، يعني تعذيبًا له، لأنه أبلغ في زجره، وأرجى لرجوعه”.
ثم قال ابن القيم: “وقال ابن شهاب -يعني الزهري- وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، وداود بن علي -يعني الظاهري- والمزني: يُحبس حتى يموت أو يتوب، ولا يُقتل. ولا شك أن قول الجمهور في هذه المسألة هو الأظهر، وأنه يُقتل، يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل”.
ثم قال رحمه الله: “هل يُقتل حدًّا، كما يُقتل المحارب والزاني، أم يُقتل كما يُقتل المرتد والزنديق -يعني كفرًا؟- قال: هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه يُقتل كما يُقتل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والثانية: يُقتل حدًّا، أي لا كفرًا، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن الحنابلة”. انتهى بتصرف.
والله تعالى أعلم.